- Latest articles

قوّة سارة العظمى هي قدرتها على اكتشاف المعجزات في كل مكان تنظر إليه؛ أتتمنى لو كان لديك ذلك أيضًا؟
عندما نفكر في المعجزات، ترجع أذهاننا إلى سيناريوهات حيّة من تحول الماء إلى نبيذ، ورؤية الأعمى فجأةً، وقيامة الموتى مرة أخرى. ما نفشل غالبًا في إدراكه هو أن المعجزات تحدث كل يوم. فهي على ما يبدو لا تقتصر على القصص القديمة من الكتاب المقدس، ولا تقتصر على الأحداث النادرة، أحداث خارقة في حياة القديسين— وهو شيء نعتقد بالتأكيد أنه لا يمكن أن يحدث لنا أبدًا. كان ألبرت أينشتاين هو الذي قال ذات مرة: “هناك طريقتان للعيش—يمكنك أن تعيش إما كما لو أن لا شيء معجزة، أو يمكنك أن تعيش كما لو أن كل شيء معجزة.” إن المفتاح الذي يفتح لنا هذا الطريق للحياة موجود بداخلنا. عندما نسمح لأنفسنا برؤية الله في كل شيء صغير يحدث في يومنا هذا، نفتح أنفسنا لتلقي المعجزات.
انسى الأمر!
واحدة من المواعظ الوحيدة التي أتذكّرها بوضوح من طفولتي المبكرة هي التي فتحت هذه العقلية في داخلي. أتذكر القصة التي رواها الكاهن على المذبح. روت امرأة وقتًا كانت تتأخر فيه عن اجتماع وسعت بشدة إلى مكان لوقوف السيارات في موقف سيارات مزدحم بالكامل. وفي حالة اليأس، صلّت إلى الله وطلبت منه أن يجد لها مساحة فارغة. في المقابل، وعدت بالتبرع بكميات كبيرة من الطعام لجمعية خيرية محليّة. عندما أنهت صلاتها، انسحبت سيارة من مكان أمامها. ظنت أنها وجدت مكانًا لركن سيارتها بنفسها، فاجابت على الفور لله قائلة: “انسى الأمر”. ما مدى سرعتنا في رفض تدخل الله والمعجزات التي تحدث أمامنا يوميًا!
حياتي اليومية مليئةٌ بالمعجزات، ولكنني لستُ مباركةً أو مميزةً أكثر من أي شخص آخر. أنا ببساطة أجدها كل يوم. ما تبحث عنه، سوف تجده، وما ترفض رؤيته، لن تكتشفه أبدًا. في حياتي الخاصة، كانت هناك مرات لا تحصى واجهتُ فيها نعمة الله وشفاعته بطرق غير متوقعة، طُرق يتجاهلها معظم الناس ولا يلاحظونها.
حيث لا توجد طريقة…
عندما كنتُ قد بدأتُ للتو في تطوير إيمان أعمق بكثير، ذهبتُ في رحلة مدرسية إلى كيبيك، كندا. كانت تلك هي السنة الأولى التي بدأت في الذهاب إليها القداس كل يوم أحد ولكن كوني جديدة في ممارسة أكثر التزامًا لإيماني، لم يخطر ببالي أنني لن أكون قادرة على حضور القداس في عطلة نهاية الأسبوع هذه. كانت الرحلة بكاملها ذات مسار صارم مصحوبة بمرافقين يوجّهون كل ما سنفعله. قمنا بجولة في المدينة، وزرنا المحلات التجارية، وذهبنا المشي لمسافات طويلة إلى شلال، وجميع الأنشطة النموذجية المتوقعة في رحلة دراسية فرنسية علمانية.
ومع ذلك، في ذلك الأحد، توقفنا بشكل غير متوقع للقيام بجولة في كاتدرائية محليّة. عندما دخلنا، بينما توجه معظم الطلاب إلى متحف الكنيسة أو أعجبوا بالعمل الفني، أدركتُ أن القداس قد بدأ قبل وصولنا بقليل. لم أتمكن فقط من حضور القداس، ولكن كان التوقيت مثاليًا حتى أنني تمكنت من تناول القربان قبل أن نضطر إلى ركوب الحافلة مرة أخرى والمغادرة! في الواقع، يخلق الله طريقة عندما يبدو أنه لا يوجد أي طريق.
الورود الخالية من الأشواك
إحدى التساعيات المفضلة لديّ للصلاة هي تساعية القديسة تيريز من ليزيو (تيريزا الطفل يسوع)، الوردة الصغيرة. قبل وفاتها، وعدت القديسة تيريزا الطفل يسوع بإمطار الورود على أولئك الذين يسعون إلى شفاعتها. تبدأ كلمات التساعية: “أيتها القديسة تريزا، الوردة الصغيرة، من فضلك اختاري لي وردة من الحديقة السماوية وارسليها لي مع رسالة حبّ، واطلبي من الله أن يمنحني النعمة التي أطلبها وأخبريه أنني سأحبه كل يوم أكثر فأكثر”.
في نهاية التساعية، يُقال إن المؤمنين يتلقون وردة كعلامة من القديسة تيريزا. بدون أدنى شك، في كل مرة، أتلقى وردة غير متوقعة في طريقي، حتى في منتصف الشتاء. خلال مناسبة، صلّيتُ تساعيّة لها ،وفي اليوم الأخير، أُعطيتُ عشوائيًا مسبحة الوردية كهدية—كلمة “وردية” تعني ” سلسلة من الورود.”
صليّتُ التساعيّة أسبوعان على التوالي لنيّة مهمة من دون إخبار أحد؛ كلا الأسبوعين، في اليوم الأخير، كان هناك شخصان مختلفان يشيران بشكل خاص إلى وردة جميلة شاهدها في الحديقة. في مناسبة أخرى، كنت أصلي التساعية من أجل التمييز بين ما إذا كان يجب على أخي الذهاب إلى مدرسة جديدة أم لا؛ ضللنا الطريق أثناء القيادة، وأخذنا جهاز تحديد المواقع العالمي (GPS) إلى طريق معقد خارج الطريق مما أدى بنا إلى أمام مبنى به وردة خشبية ضخمة على جانبه!
النقرة الصحيحة
عندما أُصبت في ظهري وكنتُ أفقد مسيرتي في الباليه، شعرتُ بأنني غير موجهة. لقد تركني العالم العلماني أشعر بأنني أفتقد هدف الله في حياتي تمامًا. أتذكر بكائي وصلاتي إلى الله ذات يوم، أسأله ما يجب أن أقوم به.
كنتُ قد بدأتُ للتو في التقاط الصور لفريق كرة القدم الخاص بأخي؛ وقد طلب بعض أصدقائه ذلك بل واستمتعوا بالصور كثيرًا. وعندما توقفتُ وفتحت هاتفي رأيتُ تعليق على تطبيق انستاغرام يضم صور أخي و أصدقائه: “هذه الصور مذهلة؛ فقط استمري في فعل ما تفعليه بالتصوير الفوتوغرافي الخاص بك.”
كانت تلك الكلمات التي كنتُ بحاجة إلى سماعها—إجابة مُصاغة تمامًا على سؤال كان الله وحده يعلم أنني أطرحه. لقد واصلتُ التقاط الصور التي انتهى بها الأمر إلى أن تكون ذات معنى كبير بالنسبة للشبان الذين تلقوها.
الله يحبنا بعمق. يريد أن يُظهر لنا حُبّه بطرق عادية وبسيطة يوميًا. كونوا منفتحين على تلقي هذا الحب، وبمجرد أن نفعل ذلك، فإنه يكشفه لنا في أماكن لم نفكر أبدًا أن ننظر إليها من قبل. -ابحثوا عن المعجزة في اللحظات العادية. وتوقعوا أن تَعبُر الأشياء الجميلة طريقكم. افرحوا بالزهور التي يزرعها الله لكي تروها في طريقكم إلى العمل. قدروا الغريب الذي يرسله الله إليكم لمساعدتكم عندما تحتاجون إليه. اعلموا أنكم لن تُتركوا بمفردكم أبدًا ولكن الله يمشي معكم يوميًا. اسمح له فقط.
'
لن تخمن أين دعاني صديقي للذهاب في موعدنا الأول!
التقيتُ به في أواخر العشرينات من عمري. خلال موعدنا الأول، سأل عمّا إذا كنتُ أرغبُ في الذهاب إلى السجود للقربان المقدس. منذ تلك اللحظة، أصبحنا عاشقين. بعد سنة، عرض علي الزواج هناك ومنذ ذلك الحين كانت علاقتنا قائمة على يسوع في القربان المقدس.
في كل مرة أجلس أمام القربان المقدس، أشعر وكأنني الطفل الذي أعطى الرب أرغفته الخمسة وسمكتان. عندما أعطيه ساعة من وقتي، يضاعف ذلك في الكثير من النعم في حياتي. من أجمل الأشياء التي مررتُ بها عندما أحمل عيوبي ومشاكلي وحزني وأحلامي ورغباتي إلى المذبح، هو أنني أتلقى السلام والفرح والحب في المقابل.
عندما بدأتُ السجود لأول مرّة، كنتُ أقصد أن أطلب من الله أن يغير الناس أو حياتهم. ولكن عندما تجلس في السجود، أمام نعمته، فإنه يفيض بمواهب وثمار الروح القدس، مما يساعدنا على أن نتعلم ببطء كيفية المسامحة وأن نكون أكثر صبرًا ومحبة ولطفًا. لم يكن وضعي يتغير؛ بدلاً من ذلك، كنتُ أتغير. عندما تجلس مع الرّب، يغير قلبك، وعقلك، وروحك بطريقة تبدأ في النظر إلى الأشياء من منظور مختلف؛ من خلال عيون المسيح.
في وقت سابق، كنتُ أبحثُ عن الثروة والشهرة والعلاقات، ولكن عندما تعرفتُ عليه في القربان المقدس، شعرتُ بهذا الحب المذهل الذي سُكب في قلبي، غيّر حياتي وملء الفراغ في قلبي.
يتحدث إلى قلبي وهذا يعطيني الحب والعزاء. إنه مثل قصة حب… لطالما أردتُ هذا الشعور المذهل بالحب في قلبي. إنه المُخلّص الذي كنتُ أبحث عنه ووجدته في السجود. سوف يجدك، وستجد الراحة في قلبك عندما تستريح فيه وأنت تعبده.
'
كنتُ مشغولةً جدًا بتعليم أطفالي كل شيء عن الإيمان، لدرجة أنني نسيتُ هذا الدرس المتكامل…
“انتظري! لا تنسي الماء المُقدس!” قرر طفلي البالغ من العمر ست سنوات أنه مستعد لقيادة صلاة ما قبل النوم بنفسه. هز زجاجة الماء المقدس-في حال غرق ” المقدس” إلى القاع—باركنا وبدأ:”يا إلهي، نحن نحبك. أنت جيد. وأنت تحبنا. حتى أنك تحبّ الأشرار. نشكرك يا إلهي. آمين.” صمتي الذهول ملأ الغرفة. لمست هذه الصلاة البسيطة قلبي بعمق. لقد أظهر لي ابني للتو كيفية الصلاة ببساطة مثل ابن الله.
كوالدة، من الصعب بالنسبة لي في بعض الأحيان الخروج من عقلية “الشخص البالغ”. أبذل الكثير من الطاقة في محاولة لمساعدة أطفالي على تكوين عادات جيدة والنمو في الإيمان، ولكن غالبًا ما أغفل ما يعلّمه لي أطفالي عن محبة يسوع. عندما جمع ابني شجاعته وصلّى بصوت عالٍ، ذكّرني أن الصلاة البسيطة والعفويّة مهمة في علاقتي اليومية مع المسيح. علمني أنه على الرغم من الشعور بعدم اليقين أو الإرباك، إلا أن صلاتي لا تزال تُرضي الرب.
تحدٍّ حقيقي
كبالغين، غالبًا ما تستهلكنا التعقيدات الدوامة للحياة الأسرية، والجداول الزمنيّة، ومسؤوليات العمل وتجعل من الصعب التحدث مع الرّب. فهمت القديسة تريزا دي كالكوتا هذا التحدي الحقيقي وقدمت بعض النصائح لأخواتها في جمعيّة مرسلات المحبة: “كيف تصلّين؟” يجب أن تذهبن إلى الله مثل طفل صغير. لا يجد الطفل صعوبة في التعبير عن عقله الصغير بالكلمات، ولكونه يعبّر عن الكثير… كونوا مثل طفلاً صغيرًا.” أظهر لنا يسوع نفسه أهمية التعلم من الأطفال: “فَدَعَا يَسُوعُ إِلَيْهِ وَلَدًا وَأَقَامَهُ فِي وَسْطِهِمْ. وَقَالَ: «اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنْ لَمْ تَرْجِعُوا وَتَصِيرُوا مِثْلَ الأَوْلاَدِ فَلَنْ تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ. فَمَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مِثْلَ هذَا الْوَلَدِ فَهُوَ الأَعْظَمُ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ.” (متى ١٨: ٢ – ٤)
كيف يمكننا أن نتعلم الصلاة مثل الأطفال؟ أولاً، اطلبوا من الله الشجاعة والتواضع، وادعوا الروح القدس لإرشادكم. بعد ذلك، ابحثوا عن مكان هادئ بعيدًا عن الضوضاء والتكنولوجيا. ابدؤوا صلاتكم بإشارة الصليب والاسم العبادي المفضل لديك الله. لقد وجدت في المحادثة أن استخدام اسم شخص ما يعمق الارتباط. (الاسم العبري ليسوع–يشوع–ويعني “الرب هو الخلاص” حتى إذا لم تكونوا متأكدين من أي اسم تريدون استخدامه، انتقوا الأبسط “يسوع” سيفي بالغرض!)
تأمين خط مباشر
الآن، حان الوقت للتحدّث مع الرب. صلوا بصوت عال، بشكل عفوي، وأخبروا الله بكل ما يتبادر إلى ذهنكم—حتى أخبروه إذا كنتم تشعروا بالحرج أو التشتت. لا تزالوا غير متأكدين من أين تبدؤوا؟ احمدوا الله على شيء، واطلبوا منه أن يغير قلبكم وصلّوا من أجل شخص بذكر اسمه. ابذلوا قصارى جهدكم و كونوا صبورين مع نفسكم. إن استعدادكم لاكتشاف بساطة صلاة الأطفال يُرضي الرّب كثيرًا. الله يُسرّ بأبنائه!
لذا، احتضنوا الدعوة للتعلم من أطفالكم. معًا يمكنكم أن تتعلموا الدخول في علاقة أعمق مع المسيح. صلّوا من أجل الشجاعة والتواضع فيما أنتم تتعلمون التحدث مع الرّب. كونوا متعمدين، وسوف تكتشفون الفرح والبساطة في الصلاة كأبناء الله!
'
منذ أن بدأت أتحدّث، كانت أمي تشتكي من كوني ثرثارةً. ما فَعَلَتهُ حيال ذلك غيّر حياتي!
قالت لي والدتي: “من المؤكد أنك تمتلكين موهبة التحدث.” عندما شَعرتْ بتطور جوّ ثرثار بشكل خاص، شَرَعتْ في تلاوة نسخة من هذه القصيدة القصيرة:
“يسمونني ليتل تشاتربوكس (ثرثارة)، لكن اسمي ليتل ماي. السبب في أنني أتحدث كثيرًا، وهو لأنني لدي الكثير لأقوله. حسنًا، لدي الكثير من الأصدقاء، والكثير يمكنك رؤيتهم، وأنا أحب كل واحد منهم والجميع يحبني. ولكنني أحب الله أفضل بين الجميع. إنه يحرسني طوال الليل وعندما يأتي الصباح مرة أخرى، يوقظني بنوره.”
بعد فوات الأوان، ربما كان القصد من القصيدة الصغيرة تشتيت انتباهي عن الحديث والسماح لأذنيّ أمي بفترة راحة مؤقتة. ومع ذلك، وبينما كانت تقرأ القصيدة الإيقاعية الحلوة، فإن معناها قدّم المزيد من الأشياء للتأمل.
وبما أن الوقت علمني دروس النضج، فقد أصبح من الواضح أن الكثير من الأفكار أو الآراء التي تدور في رأسي يجب تصفيتها أو إسكاتها، ببساطة لأنها لم تكن ضرورية للمشاركة. أتعلّم كيفية قمع ما يأتي بشكل طبيعي استغرق الكثير من الممارسة والانضباط الذاتي والصبر. ومع ذلك، كانت لا تزال هناك لحظات عندما كانت هناك حاجة لقول بعض الأشياء بصوتٍ عالٍ أو بالتأكيد كنتُ سأنفجر! لحسن الحظ، كان لوالدتي والتعليم الكاثوليكي دورًا أساسيًا في تعريفي إلى الصلاة. كانت الصلاة ببساطة بمثابة التحدث إلى الله كما لو كنتُ أتحدثُ إلى الصديق المفضّل. علاوة على ذلك، ولسعادتي البالغة، عندما علمتُ أن الله كان معي دائمًا ومتلهفًا جدًا للاستماع إلي في أي وقت وفي أي مكان، فكرتُ: “الآن، يجب أن يكون هذا توافقًا مثاليًا في السماء!”
تَعلُّم الاستماع
إلى جانب النضج أتى الشعور بأن الوقت قد حان لتطوير علاقة أعمق مع صديقي، الله. يتواصل الأصدقاء الحقيقيون مع بعضهم البعض، لذلك أدركتُ أنه لا ينبغي أن أكون الشخص الذي أجرى كل الحديث. ذكرني سفر الجامعة ٣: ١: “لِكُلِّ شَيْءٍ زَمَانٌ، وَلِكُلِّ أَمْرٍ تَحْتَ السَّمَاوَاتِ وَقْتٌ” وقد حان الوقت للسماح لله ببعض فرص الدردشة بينما كنتُ أستمع. استغرق هذا النضج الجديد أيضًا الممارسة والانضباط الذاتي والصبر للتطور. أُخصّص الوقت لزيارة الرّب بانتظام في منزله في الكنيسة أو كنيسة العبادة وساعد ذلك في نمو هذه العلاقة. هناك شعرتُ بأنني أكثر حرية من المشتتات التي كانت تغري أفكاري بالتجول. كان الجلوس في صمت غير مريح في البداية، لكنني جلستُ وانتظرتُ. كنتُ في منزله. كان المُضيف. وكنتُ الضّيف. لذلك، احترامًا، بدا من المناسب أن أتبع قيادته. ومرّت الكثير من الزيارات في صمت.
ثم ذات يوم، من خلال الصمت، سمعتُ همسًا لطيفًا في قلبي. لم يكن في رأسي أو في أذني… لقد كان في قلبي. لقد ملأ همسهُ الرقيق والمباشر قلبي بدفء مُحبّ. لقد أدركتُ حقيقة ما: ذلك الصوت… بطريقةٍ ما، كنتُ أعرفُ ذلك الصوت. كان مألوفًا جدًا. يا إلهي، يا صديقي، كان هناك. لقد كان صوتًا سمعته طوال حياتي، ولكن مما أثار استيائي، أدركتُ أنني غالبًا ما أُغرقه بسذاجة بأفكاري وكلماتي.
الوقت لديه أيضًا وسيلة للكشف عن الحقيقة. لم أكن أدرك أبدًا أن الله كان دائمًا موجودًا ليحاول جذب انتباهي وكان لديه أشياء مهمة ليقولها لي. بمجرد أن فهمت، لم يعد الجلوس في صمت غير مريح. في الواقع، لقد كان وقتًا من الشوق والانتظار لسماع صوته الرقيق، لسماعه يهمس بحب مرة أخرى إلى قلبي. لقد عزز الوقت علاقتنا بحيث لم يعد الأمر يقتصر على حديث أحدنا أو الآخر، بل بدأنا في الحوار. يبدأ صباحي بالصلاة من خلال تقديم اليوم القادم له. ثم، على طول الطريق، كنتُ أتوقف وأحدثه كيف كان يسير اليوم. كان يواسي، ينصح، يُشجّع، وأحيانًا يوبّخني عندما أحاول أن أستشف إرادته في حياتي اليومية. محاولة فهم إرادته دفعتني إلى الكتاب المقدس حيث، مرة أخرى، كان يهمس في قلبي. كان من المُمتع أن أدرك أنه كان أيضًا ثرثارًا إلى حدّ ما، ولكن لماذا يجب أن أتفاجأ؟ بعد كل شيء، أخبرني في تكوين ١: ٢٧ أنني خلقت على صورته ومثاله!
تهدئة النفس
الوقت لا يقف ساكنًا. لقد خلقها الله وهي هدية منه لنا. لحسن الحظ، لقد مشيتُ مع الله لفترة طويلة، ومن خلال نزهاتنا واحاديثنا، فهمت أنه يهمس لأولئك الذين يسكّتون أنفسهم لسماعه، تمامًا كما فعل مع إيليا. “وَإِذَا بِالرَّبِّ عَابِرٌ وَرِيحٌ عَظِيمَةٌ وَشَدِيدَةٌ قَدْ شَقَّتِ الْجِبَالَ وَكَسَّرَتِ الصُّخُورَ أَمَامَ الرَّبِّ، وَلَمْ يَكُنِ الرَّبُّ فِي الرِّيحِ. وَبَعْدَ الرِّيحِ زَلْزَلَةٌ، وَلَمْ يَكُنِ الرَّبُّ فِي الزَّلْزَلَةِ. وَبَعْدَ الزَّلْزَلَةِ نَارٌ، وَلَمْ يَكُنِ الرَّبُّ فِي النَّارِ. وَبَعْدَ النَّارِ صَوْتٌ مُنْخَفِضٌ خَفِيفٌ.” (سفر الملوك الأول ۱٩: ١١- ١٢)
في الواقع، يُرشدنا الله إلى إسكات أنفسنا حتى نتمكن من التّعرف عليه. واحدةً من آيات الكتاب المقدس المفضلة لدي هي مزمور ٤٦: ١٠، حيث أخبرني الله بصراحة أن “اسْتَكِينُ وَاعْلَمُ أَنِّه هوَ اللهُ.” فقط من خلال تهدئة ذهني وجسدي يمكن أن يكون قلبي هادئًا بما يكفي لسماعه. يكشف عن نفسه عندما نستمع إلى كلمته لأن “الإِيمَانُ نَتِيجَةُ السَّمَاعِ، وَالسَّمَاعُ هُوَ مِنَ التَّبْشِيرِ بِكَلِمَةِ الْمَسِيحِ.”(رومية ١٠: ١٧)
منذ زمن بعيد، عندما تلت والدتي قصيدة الطفولة تلك، لم تكن تعلم أن بذرةً ستُزرع في قلبي. من خلال محادثاتي مع الله في الصلاة، نَمَتْ تلك البذرة الصغيرة ونَمَتْ، حتى بعد طول انتظار، “أحبُّ الله أفضل الجميع”! إنه يحرسني طوال الليل، خاصةً الأوقات المظلمة في الحياة. علاوة على ذلك، استيقظتْ روحي عندما تحدث عن خلاصي. وهكذا، يوقظني دائمًا بنوره. شكرًا لك يا أمي!
لقد حان الوقت لتذكيرك، صديقي العزيز، أن الله يحبك! مثلي، أنتَ أيضًا خُلقتَ على صورة الله ومثاله. يريد أن يهمس لقلبك، ولكن من أجل ذلك، كُنّ ساكنًا وتعرّف عليه كإله. أدعوك، دع هذا يكون وقتك وموسِمك للسماح لنفسك بتطوير علاقة أعمق مع الرب. تحدث معه في الصلاة باعتباره صديقك العزيز وطوّر حوارك الخاص معه. عندما تستمع، لن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تُدرك أنه عندما يهمس لقلبك، هو أيضًا “ثرثار.”
'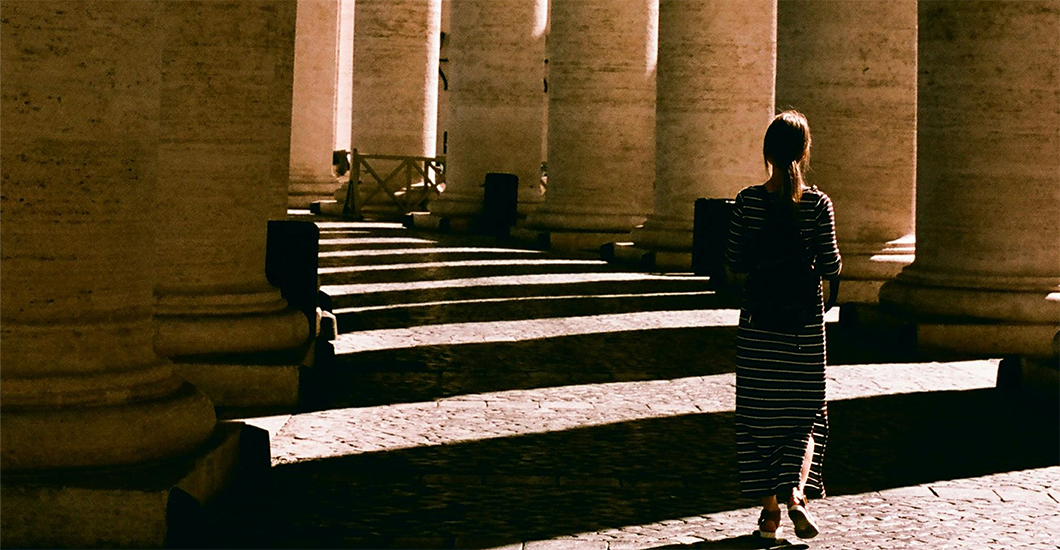
روما، كاتدرائية القديس بطرس، لقاء البابا…هل يمكن أن تكون الحياة مليئة بأحداث أكثر؟ اكتشفتُ أنه يمكن أن تكون.
حدث تحوّلي إلى الإيمان الكاثوليكي خلال رحلتي إلى روما، حيثُ كنتُ محظوظةً للدراسة لجزءٍ من شهادتي. نظّمت الجامعة الكاثوليكية التي انضممتُ لها عدة لقاءات مع البابا فرانسيس كجزء من الرحلة. في إحدى الليالي، كنتُ جالسةً في كاتدرائية القديس بطرس، أستمع إلى المسبحة الوردية التي تُتلى باللاتينية عبر مكبر الصوت بينما كنتُ أنتظرُ بدء خدمة القداس. على الرغم من أنني لم أفهم اللاتينية في ذلك الوقت، ولا أعرف ما هي المسبحة، إلا أنني تعرّفتُ بطريقةٍ ما على الصلاة. لقد كانت لحظة تعميد باطني دفعتني في النهاية إلى أن أوكل حياتي كلها إلى يسوع من خلال شفاعة مريم. بدأت رحلة التحول هذه التي بلغت ذروتها في معموديتي في الكنيسة الكاثوليكية بعد عام، وقصّة الحب التي تلت ذلك بعد فترة وجيزة.
اكتشاف اللّحظات
لقد وجدتُ نفسي ببطء أبني أُسس علاقتي وأقوم بالاِحتِذَاء بمريم في هذه العملية دون وعي. ركعتُ عند قدميه في الصلاة كما فعلت مريم في الجُلجُلة، أسعى لتعميق علاقتي بالمسيح. أواصل هذه الممارسة اليوم، وأنا أدرس وجهه وجروحه وضعفه ومعاناته. والأكثر أهميّة، هو أنني ألتقي به كل يوم لمواساته لأنني لا أستطيع تحمّل فكرة كونه وحيدًا على الصليب. من خلال التأمل في آلامه، أجد أنني أستطيع أن أُقدّر بعمق أهمية المسيح الحيّ، الذي يعيش فينا اليوم.
عندما كرّستُ نفسي لهذه الممارسة، شعرتُ أن يسوع ينتظرني في صلواتي اليومية، ويتوق إلى إخلاصي، ويسعى إلى رفقتي. كلما حملتهُ في صلاة صامتة، كلما بدأتُ أشعرُ بحزن عميق وأسى على الثمن الذي دفعه يسوع لحياتي وحياة الآخرين. لقد ذرفتُ الدموع من أجله. لقد سجنتهُ في قلبي وواسيته من خلال الصلاة، مما يعكس رعاية مريم الرقيقة لابنها. إن إدراك المحبة المضحيّة التي قادت يسوع إلى الصليب أثارت مشاعر أمومية عميقة بداخلي، مما أجبرني على تسليم كل شيء له. بفضل نعمة السيدة العذراء، قدّمتُ نفسي تمامًا ليسوع، وسمحتُ له بتحويلي بينما ازدهرت علاقتنا.
التضحية
عندما عانيت من خسارة كبيرة قبل عامين، واصلت هذه الممارسة اليومية، على الرغم من أن تركيز حزني قد تحول. الدموع التي أذرفها لم تعد له بل لنفسي. لم أكن أستطيع أن أفعل شيئًا سوى السقوط عند قدميّ ربنا في محنتي ويأسي المطلقتين، على الرغم من أنني شعرت بالأنانية. عندها أظهر لي الله كيف يمكن مشاركة المعاناة الفدائية ليس فقط من خلال مشاهدة تضحيته في الصلاة، ولكن من خلال الدخول في آلامه.
فجأةً، لم تعد معاناته خارجية بالنسبة لي، بل كانت شيئًا حميميًا لدرجة أنني أصبحتُ شخصًا واحدًا مع المسيح على الصليب. لم أعد وحدي في معاناتي. في المقابل، كان هو الذي حملني في صلاة صامتة، هو الذي حزن عليّ وشارك حزني. لقد ذرف الدّموع من أجلي وفتح قلبه حيث التجأت وأصبحتُ سجينةً له. كنت أسيرةً في حبه.
السير على الطريق الصعب
إن الاِحتِذَاء بمريم يقودنا مباشرةً إلى قلب يسوع، يعلمنا جوهر التوبة الحقيقية والرحمة اللامحدودة التي تنبع من محبته. قد تكون هذه الرحلة صعبة، وتتطلب منا المشاركة في أعباء صليب المسيح. ومع ذلك، من خلال تجاربنا وأحزاننا، يمكننا أن نجد العزاء في حضوره المريح، مع العلم أنه لا يتخلى عنا أبدًا. باتباع مثال مريم، ندعوها لإرشادنا في تعميق علاقتنا مع يسوع، ربنا ومخلصنا، والمشاركة في معاناته الفدائية. من خلال القيام بذلك، نصبح شهداء أحياء لآلام ومعاناة أولئك الذين لم يلتقوا بالمسيح بعد، وفي نفس العملية، نُشفى نحن أنفسنا.
عندما نقتضي بمحبة مريم الأمومية لابنها، فإننا نقترب من جوهر آلامه ونصبح أوعية لنعمته الشافية. من خلال تقديم آلامنا الخاصة بالاتحاد مع المسيح، نُصبح شهودًا أحياء لمحبته ورحمته، ونجلب العزاء لأولئك الذين لم يقابلوه بعد. في هذه العملية المقدسة، نجد الشفاء لأنفسنا ونصبح أدوات لرحمة الله، وننشر نوره إلى المحتاجين. وبالمثل، نتعلم تقبّل الصلبان في حياتنا بشجاعة، مع العلم أنها مسارات لاتحاد أعمق مع المسيح.
من خلال شفاعة مريم، نسترشد نحو فهم عميق للمحبة المضحيّة التي دفعت يسوع إلى بذل حياته من أجلنا. بينما نسير في طريق التلمذة، نسير على خطى مريم، نحن مدعوون لتقديم آلامنا ونضالاتنا ليسوع، واثقين في قوته التحويلية لتحقيق الشفاء والفداء في حياتنا.

ليس من السهل التنبؤ بما إذا كنت ستكون ناجحًا أو ثريًا أو مشهورًا، ولكن هناك شيء واحد مؤكد– الموت في انتظارك في النهاية.
أُقضي جزءًا لا بأس به من وقتي هذه الأيام في ممارسة فن الموت. يجب أن أقول، أنا أستمتع بكل لحظة من هذا التمرين، على الأقل منذ أن أدركتُ أنني دخلتُ النهاية الثقيلة لمقاييس الزمن.
لقد تجاوزتُ السبعين عامًا، بشكل جيد وحقيقي، ولذلك بدأت أفكر بجديّة: ما هي الاستعدادات الإيجابية التي قمتُ بها لمواجهة حتميّة وفاتي؟ كم هي الحياة التي أعيشها غير قابلة للصدأ؟ هل حياتي خالية قدر الإمكان من الخطيئة، خاصة خطايا الجسد؟ هل هدفي النهائي هو إنقاذ روحي الخالدة من الخطيئة الأبدية؟
الله، في رحمته، وقد سمح لي بـ “وقت اضافي” في هذه اللعبة من الحياة، حتّى أتمكّن من ترتيب شؤوني (وخاصة الشؤون الروحية)أتجاوز القمة وأدخل في ظلال وادي الموت. كان لدي ما يزيد عن عمري لحل هذه الأمور، ولكن مثل كثيرين، أهملتُ أهم الأشياء في الحياة، مفضلاً البحث بحماقة عن المزيد من الثروة والأمن والإشباع الفوري. لا أستطيع أن أقول إنني على وشك النجاح في مساعيَّ التي أمارسها، حيث لا تزال تشتتات الحياة تزعجني، على الرغم من تقدمي في السن. هذا الصّراع المستمر مُزعج للغاية ومُعذّب للغاية، ولكن عندما لا يزال من الممكن إغراء المرء، فإن مثل هذه المشاعر الضائعة غير مجدية.
الهروب من الذي لا مفر منه
على الرُغم من تربيتي الكاثوليكية وحثّها على الاحتضان والتطلع إلى الخبطة الحتمية على كتف “ملاك الموت” الإلهي، لا أزال أتوقّع تلك الرسالة من الملك تهنئني على الوصول إلى “الصفر الكبير”. بالطبع، مثل الكثيرين من فئتي العمرية، أتواصل لكي أتجنّب ما لا مفر منه من خلال تبنّي أي حافز للمساعدة في إطالة وجودي الأرضي بالأدوية أو النظافة أو النظام الغذائي أو بأي وسيلة ممكنة.
الموت أمر لا مفرّ منه للجميع، حتى بالنسبة لل “بابا”، عمتنا المحبوبة بياتريس، والملوك. لكن كُلما طالت مُدّة هروبنا مما لا مفر منه؛ كُلّما ظهر بصيص الأمل هذا في نفوسنا-بحيثُ يمكننا دفع الظرف، ووضع نفحة أخرى من التنفس في ذلك البالون، وتمديده إلى أقصى حدوده الخارجية. أفترض، بطريقة ما، أن هذا قد يكون هو الحل لتمديد تاريخ الوفاة بنجاح – تلك الإيجابية، تلك المقاومة للخلود. لطالما فكرتُ، إذا كان بإمكاني تجنُّب الضرائب غير المبررة بأي وسيلة، فلماذا لا أحاول تجنُّب اليقين الآخر، الموت؟
يُشير القديس أوغسطينوس إلى الموت على أنه: “الديْن الذي يجب دفعه.” ويُضيف المطران أنتوني فيشر: “عندما يتعلق الأمر بالموت، فإن الحداثة هي تهرب ضريبي، وكذلك ثقافتنا الحالية في إنكار الشيخوخة والضعف والموت.”
ينطبق الشيء نفسه على صالات اللياقة البدنية. أحصيت الأسبوع الماضي فقط، خمس مؤسسات من هذا القبيل في مجتمعنا الصغير نسبيًا، في الضاحية الغربية الخارجية لسيدني. هذه الرغبة الجونونيّة في التمتع باللياقة والصحة هي في حد
ذاتها نبيلة وجديرة بالثناء، بشرط ألا نأخذها على محمل الجد لأنها قد تؤثر على كل جانب من جوانب حياتنا على حسابها. وأحيانًا، يمكن أن تؤدي إلى النرجسيّة. يجب أن نكون واثقين من قدرتنا ومواهبنا ولكن نضع في اعتبارنا فضيلة التواضع التي تبقينا على أرض الواقع، حتى لا نتجول بعيدًا عن إرشادات الله للحياة الطبيعية.
إلى أقصى درجة
حتى أننا نحاول ترويض الشيخوخة والموت، بحيث يحدثان وفقًا لشروطنا الخاصة من خلال التجاوزات التجميلية والطبية، أو الحفظ بالتبريد، أو سرقة الأعضاء بشكل غير قانوني من أجل زرعها، أو الطريقة الأكثر شيطانية لمحاولة التغلب على الموت الطبيعي عن طريق القتل الرحيم… كما لو كان هناك ليس هناك ما يكفي من الحوادث المؤسفة التي تأخذ حياتنا قبل الأوان.
ومع ذلك، يخشى معظم الناس فكرة الموت. يمكن أن يكون الأمر مُشّلاً ومحيرًا ومحبطًا، لأنه سيكون نهاية حياتنا الأرضية، ولكن الأمر يتطلب ببساطة حبة خردل من الإيمان لتغيير كل مشاعر “نهاية العالم” وفتح آفاق جديدة تمامًا من الأمل. والفرح والترقّب الممتع والسعادة.
مع الإيمان في الآخرة مع الله وكل ما ينطوي عليه، والموت هو ببساطة الباب الضروري الذي يجب أن يُفتح لنا للمشاركة في كل وعود السماء. يا له من ضمان، من إلهنا القدير، أنه من خلال الإيمان بابنه يسوع وعيش حياة بناء على تعليماته، تأتي الحياة بعد الموت-حياة على أكمل وجه. ولذا يمكننا أن نطرح السؤال بثقة: “يا موت أين نصرك، أيها الموت أين شوكتك؟” (١ كورنثوس ١٥: ٥٨)
القليل من الإيمان
عند دخول المجهول الكبير، من المتوقع حدوث خوف، ولكن على عكس هاملت في مسرحية شكسبير، الذي قال: “الموت هو البلد غير المكتشف الذي لا يعود مسافر من مولده”، نحن الذين وهبنا هبة الإيمان، لقد أظهرنا لنا دليل على أن بعض النفوس قد عادت من أحشاء الموت لتشهد على ذلك الضلال.
التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية يُعلّم أن الموت هو نتيجة الخطيئة. إن التعليم الكنسي، باعتباره المفسر الحقيقي لتأكيدات الكتاب المقدس والتقليد، يُعلم أن الموت دخل إلى العالم بسبب خطيئة الإنسان. “على الرّغم من أن طبيعة الإنسان مميتة، إلا أن الله قد قدر له ألا يموت. لذلك كان الموت مخالفًا لخطط الله الخالق ودخل العالم نتيجةً للخطيئة.” كتاب الحكمة يؤكد هذا. “الله لم يصنع الموت، ولا يسعد بموت الأحياء. لقد خلق كل شيء حتى يستمر في الوجود وكل شيء خلقه نافع وصالح.” (الحكمة ١: ١٣-١٤ ، 1 كورنثوس ١٥: ٢١ ، رومية ٦: ٢١-٢٣)
بدون إيمان حقيقي، يبدو الموت وكأنه إبادة. لذلك، ابحث عن الإيمان لأن هذا هو ما يغير فكرة الموت إلى أمل الحياة. إذا لم يكن الإيمان الذي تمتلكه قويًا بما يكفي للتغلب على الخوف من الموت، فاستعجل لتقوية هذا الإيمان القليل إلى إيمان كامل به الذي هو الحياة، لأنه بعد كل شيء، ما هو على المحكّ هي حياتك الأبدية. لذلك، دعونا لا نترك الأشياء كثيرًا للصدفة.
أتمنى لكم رحلة آمنة، أراكم في الجانب الآخر!
'
شيء ما جعلني أقف ساكنةً في ذلك اليوم…وتغير كل شيء.
كنتُ على وشك أن أبدأ مجموعة المسبحة الوردية دار الرعاية حيث أعمل كممارسة رعاية رعوية عندما لاحظتُ نورمان البالغ من العمر ٩٣ عامًا يجلس في الكنيسة وحده، ويبحث بائسًا. بدت عليه رجفات مرض باركنسون واضحة تمامًا.
انضممتُ إليه وسألتُ كيف حاله. هز كتفيه بطريقة مهزومة، وتمتم بشيء باللغة الإيطالية وبكى تمامًا. كنتُ أعلمُ أنه لم يكن في مكانٍ جيد. كانت لغة الجسد مألوفة جدًا بالنسبة لي. كنتُ قد رأيتُ ذلك في والدي قبل أشهر قليلة من وفاته؛ الإحباط والحزن والوحدة والقلق من “لماذا يجب عليّ مواصلة العيش على هذا النحو،” ألم جسدي واضح من الرأس المجعّد والعينين الزجاجيتين…
أصبحتُ عاطفيّة ولم أستطع التّحدث لبضع لحظات. في صمت، وضعتُ يديّ على كتفيهِ، مؤكّدةً له أنني هناك معه.
عالم جديد كليًا
كان الصّباح وقت الشاي. كنتُ أعلمُ أنه بحلول الوقت الذي يتمكّن فيه من الذهاب إلى غرفة الطعام، كان يغيب عن خدمة تقديم الشاي. لذا عرضتُ أن أُقدّم له كوب. بواسطة لغتي الإيطالية البسيطة، تمكنتُ من تمييز تفضيلاته.
في مطبخ الموظفين القريب، حضّرتُ له كوبًا من الشاي مع الحليب والسكر. حذّرته من أنه حارًا جدًا. ابتسمَ، مُشيرًا إلى أن هكذا يُحبّهُ. قمتُ بتحريك المشروب عدّة مرات لأنني لم أرغب في أن يحترق، وعندما شعر كلانا أن هذه هي درجة الحرارة المناسبة، قدّمتهُ لهُ. بسبب مرضه بالباركنسون، لم يستطع حمل الكأس بثبات. أكدتُ له أنني سأحمل الكأس؛ بيديّ ويده المرتجفة، ارتشف الشاي، مبتسمًا بشكل مُبهج كما لو كان أفضل مشروب احتساهُ في حياته. أنهى كل قطرة من الشاي! وسرعان ما توقف رجفاته، وجلس، بأكثر يقظة. وهتف بابتسامته المتميزة: “غراسياس!” حتى أنه انضم إلى السكان الآخرين الذين سرعان ما توجهوا إلى الكنيسة، وبقى هناك من أجل المسبحة الوردية.
كان مجرّد كوب من الشاي، ومع ذلك كان يعني له بمثابة العالم كلّه؛ ليس فقط لإرواء عطش جسدي ولكن أيضًا لجوعٍ عاطفي!
ذكرى
بينما كنتُ أساعده في شرب كوبه، تذكّرتُ أبي. الأوقات التي استمتع فيها بالوجبات التي تناولناها معًا بدون استعجال، والجلوس معه في مكانه المفضل على الأريكة بينما كان يعاني من آلام السرطان، وأنضمُ إليه في سريره للاستماع إلى موسيقاه المفضلة، ومشاهدة قداسات الشفاء معًا عبر الإنترنت…
ما الذي دفعني للقاء نورمان عند حاجته ذلك الصباح؟ بالتأكيد لم تكن طبيعتي الضعيفة والجسدية. كانت خطتي هي تهيأت الكنيسة بسرعة لأنني تأخرت. كانت لدي مهمة علي إنجازها.
ما الذي جعلني أقف ساكنةً؟ كان يسوع، الذي توّج نعمته ورحمته في قلبي لتلبية احتياجات شخص ما. في تلك اللحظة، أدركتُ عمق تعليم القديس بولس: “فَأَحْيَا لاَ أَنَا، بَلِ الْمَسِيحُ يَحْيَا فِيَّ”. (غلاطية ٢: ٢٠)
أتساءل عندما أبلغ سن نورمان وأنا أشتاق لكابتشينو، “مع حليب اللوز، نصف قوي، ساخن جدًا،” هل سيعدّهُ لي أحد كوبًا بهذه الرحمة والنعمة أيضًا؟
'
هل ستعود حياتي إلى طبيعتها؟ كيف يمكنني ربما مواصلة عملي؟ خلال التفكير في هذه الأمور، برز حل رهيب في رأسي…
كنتُ أجد الحياة مرهقة للغاية. خلال سنتي الخامسة في الكليّة، كان ظهور اضطراب ثنائي القطب يعيق جهودي لإكمال شهادتي في التدريس. لم يكن لدي أي تشخيص في وقتها، ولكن كنت أعاني من الأرق، وبدوتُ مُنهكة ومُهمِلة، مما أعاق احتمالات عملي كمدرّسة. وبما أن لدي ميولًا طبيعية قوية نحو الكمالية، شعرتُ بالخجل الشديد والخوف لدرجة أنني كنت أخذل الجميع. تصاعدت مشاعر الغضب واليأس، والاكتئاب لدي. كان الناس قلقين بشأن تراجعي وحاولوا المساعدة. حتى أنني أُرسلتُ إلى المستشفى بسيارة إسعاف من المدرسة، لكن الأطباء لم يجدوا أي خطأ باستثناء ارتفاع ضغط الدم. صلّيتُ ولكن لم أجد أي مُواساة. حتى قداس عيد الفصح- الزمن المفضّل لدي – لم يكسر الحلقة المفرغة. لماذا لا يساعدني يسوع؟ شعرتُ بالغضب منه. أخيرًا، توقفتُ عن الصلاة.
مع استمرار هذا، يوما بعد يوم، شهرًا بعد شهر، لم أكن أعلم ماذا أفعل. هل ستعود حياتي إلى طبيعتها؟ بدا الأمر غير مُحتمل. ومع اقتراب التخرج، زاد خوفي. التدريس مهنة صعبة مع فترات راحة قليلة، وسوف يحتاج الطلاب لي أن أبقى متزنة العقل أثناء التعامل مع احتياجاتهم المتعددة وتوفير بيئة تعليمية جيّدة. كيف يمكنني القيام بذلك في وضعي الحالي؟ خطر في عقلي حلّ رهيب: “يجب أن تقتلي نفسك” بدلاً من إلقاء تلك الفكرة وإرسالها مباشرة إلى الجحيم حيث تنتمي، تركتها تجلس. بدا الأمر وكأنه إجابة بسيطة ومنطقية لمعضلتي. أردت فقط أن أكون مخدّرة بدلا من التّعرض لهجوم مستمر.
للأسف الشديد، اخترتُ اليأس. لكن، فيما كنتُ أتوقع أن تكون لحظاتي الأخيرة، فكّرتُ في عائلتي وفي الشخص الذي سبق وكنتُ عليه. وبندم حقيقي، رفعتُ رأسي إلى السماء وقلت: “أنا آسفة يا يسوع. آسفة على كل شيء. أعطني فقط ما أستحق.” اعتقدتُ أن هذه ستكون الكلمات الأخيرة التي سأقولها في هذه الحياة. لكن كان لالله خطط أخرى.
الاستماع إلى الإله
كانت والدتي، من خلال العناية الإلهية، تُصلي مسبحة الرحمة الإلهية في تلك اللّحظة بالذات. فجأة، سمعت الكلمات بصوتٍ عالٍ وواضحٍ في قلبها “اذهبي وابحثي عن إلين.” وضعت بطاعةٍ حبات المسبحة جانبًا ووجدتني على أرضية المرآب. فَهِمت بسرعة، وصَرَخت برهبة: “ماذا تفعلين؟!” بينما كانت تسحبني إلى المنزل.
كان والداي حزينين. لا يوجد كتاب قواعد لمثل هذه الأوقات، لكنهم قرروا اصطحابي إلى القدّاس. لقد كُسرتُ تمامًا، وكنتُ بحاجة إلى مُخلّص أكثر من أي وقت مضى. كنتُ أتوق إلى لحظة المجيء إلى يسوع، لكنني كنت مُقتنعًا بأنني آخر شخص في العالم يريد أن يراه. أردتُ أن أُصدّقَ أن يسوع هو راعي وسيأتي وراء خرافه الضّالة، لكن الأمر كان صعبًا لأنه لم يتغير شيء. كنت لا أزال مُنهكة من كراهية الذات الشديدة، ومُجهدة بالظلام. كان تقريبًا مؤلمًا جسديًا.
أثناء إعداد الهدايا، انهرتُ بالبكاء. لم أبكي لفترة طويلة حقًا، لكن بمجرد أن بدأتُ، لم أستطع التوقف. لقد كنتُ في أقصى طاقتي، ولم يكن لدي أي فكرة إلى أين أذهب بعد ذلك. ولكن بينما كنتُ أبكي، ارتفع الثقل ببطء، وشعرتُ بنفسي مغمورة في رحمته الإلهية. لم أكن أستحق ذلك، لكنه أعطاني هبة نفسه، وعرفت أنه أحبني بنفس القدر في أدنى مستوياتي بقدر ما أحبني في أعلى نقاطي.
في السعي وراء الحب
في الأيام التالية، بالكاد تمكنت من مواجهة الله، لكنه استمر في الظهور وملاحقتي في الأشياء الصغيرة. أعدتُ تأسيس التواصل مع يسوع بمعونةٍ من صورة الرحمة الإلهية في غرفة الجلوس لدينا. حاولت التحدث، وكنتُ أشكي في الغالب من النضال ثم شعرت بالسوء حيال ذلك في ضوء الإنقاذ الأخير.
بغرابة، اعتقدتُ أنني أستطيع سماع صوت رقيق يهمس: “هل تعتقدين حقًا أنني سأترككِ تموتين؟ أحبّكِ. لن أتركك أبدًا. أعدكِ ألا أترككِ أبدا. كل شيء يُغفر. ثقي في رحمتي.” أردتُ أن أصدق هذا، لكنني لم أستطع أن أثقَ في أنه كان صحيحًا. كنت أشعرُ بالإحباط عند الجدران التي كنت أقوم ببنائها، لكنني واصلت الحديث مع يسوع: “كيف أتعلم أن أثق بك؟”
فاجأني الجواب. إلى أين تذهب عندما لا تشعر بأي أمل ولكن عليك أن تستمر في العيش؟ عندما تشعر أنك غير محبوب على الإطلاق، فخور جدًا بقبول أي شيء ولكنك ترغب بشدة في أن تكون متواضعًا؟ بعبارات أخرى، أين تريد أن تذهب عندما تريد المصالحة الكاملة مع الآب، الابن، والروح القدس ولكنك خائف جدًا وغير مؤمن بالاستقبال المُحبّ لتجد طريقك إلى المنزل؟ الجواب هو السيدة مريم العذراء المباركة، والدة الإله، وملكة السماء.
بينما كنتُ أتعلّم الثقة، لم تُغضب محاولاتي المحرجة يسوع. كان يناديني لأقترب، لأقترب إلى قلبه المقدّس، من خلال والدته المباركة. لقد وقعت في حبه وإخلاصه.
يمكنني أن أعترف بكل شيء لمريم. على الرغم من أنني كنت أخشى ألا أتمكن من الوفاء بوعدي لأمي الأرضية لأنني، بمفردي، كنتُ لا أزال بالكاد أمتلك إرادة الحياة، إلا أن والدتي ألهمتني لتكريس حياتي لمريم العذراء، واثقةً من أنها ستساعدني في تجاوز هذه المحنة. لم أكن أعلم الكثير عمّا يعنيه ذلك، ولكن كتاب “٣٣ دايز تو مورنين غلوري” (٣٣ يومًا لمجد الصباح) و “كونسولينغ ذا هارت أوف جيزوسس” (تعزية قلب يسوع) تأليف الأب مايكل إي جايتلي، آباء الحبل بلا دنس المريميين (MIC)، ساعداني على الفهم. فالأم المباركة مستعدة دائما لتكون شفيعتنا، ولن ترفض أبدًا طلبًا من ابن يريد العودة إلى يسوع. أثناء مروري بالتكريس، عقدت العزم على عدم محاولة الانتحار مرة أخرى بهذه الكلمات: “مهما حدث، فلن أستسلم. ”
في هذه الأثناء، بدأتُ المشي لمسافات طويلة على الشاطئ بينما تحدثتُ مع الله الآب وتأملتُ في مَثَل الابن الضال. حاولتُ أن أضع نفسي في مكان الابن الضال، لكن الأمر استغرق مني بعض الوقت للاقتراب من الله الآب. أولاً، تخيلتهُ على بعد مسافة منّي، ومن ثم قادم إليّ. وفي يوم آخر، تخيلتهُ يجري نحوي مع أن ذلك جعله يبدو مضحكًا في أعين أصدقائه وجيرانه.
أخيرًا، جاء اليوم الذي استطعتُ فيه تخيّل نفسي بين يديّ الآب، ومن ثمّ يتم الترحيب بي ليس فقط لمنزله بل إلى مقعدي على طاولة العائلة. كما تصورته يسحب كرسي لي، لم أعد امرأة شابة عنيدة ولكن فتاة تبلغ من العمر ١٠ سنوات مع نظارات مضحكة وقصة شعر بوب. عندما قبلتُ حب الآب لي، أصبحتُ مثل طفل صغير مرة أخرى، أعيشُ في الوقت الحاضر وأثق به تمامًا. لقد وقعت في حب الله وبِرّه. لقد أنقذني الراعي الصالح من سجن الخوف والغضب، ويستمر في قيادتي على الطريق الآمن ويحملني عندما أتعثّر.
الآن، أريد أن أشارك قصتي حتى يتمكن الجميع من معرفة فضل الله ومحبته. يتدفق قلبهُ المقدّس بالعطاء الحب والرحمة فقط لأجلك. يريد أن يحبك ببذخ، وأنا أشجعك على الترحيب به دون خوف. لن يتخلّى عنك أو يخذلك. اخطي إلى نوره وعُد للديار.
'
في أحلك الوديان وأصعب اللّيالي، سَمِعتْ بليندا صوتًا ظلّ يناديها مرّة أخرى.
تركتنا أمّي عندما كنتُ في الحادية عشرة من عمري. في ذلك الوقت، اعتقدتُ أنها غادرت لأنها لا تُريدني. ولكن في الواقع، بعد سنوات من المعاناة بصمت من خلال سوء المعاملة الزوجية، لم تعد قادرة على الصمود. بقدر ما أرادت أن تُنقذنا، كان والدي قد هدد بقتلها إذا أخذتنا معها. لقد كان الأمر أكثر من اللازم لتقبله في مثل هذه السن المبكرة، وبينما كنتُ أسعى جاهدًا للتغلب على هذا الوقت العصيب، بدأ والدي في دائرة من الإساءة التي ستطاردني لسنوات قادمة.
الوديان والتلال
لتخدير الألم من سوء معاملة والدي والتعويض عن الشعور بالوحدة من التخلي من والدتي، بدأتُ اللّجوء إلى جميع أنواع تقنيات “التعافي”. وعندما لم أستطع تحمل الإساءة بعد الآن، هربتُ مع تشارلز، صديقي من المدرسة. تواصلتُ من جديد مع والدتي خلال هذا الوقت، وسكنتُ معها ومع زوجها الجديد لفترة من الوقت.
في ١٧من العمر، تزوجتُ تشارلز. كان لعائلته تاريخ من السجن، وسُرعان ما تبعها هو أيضًا. لقد استمريتُ في الخروج مع نفس المجموعة من الأشخاص، وفي النهاية، سقطتُ أنا أيضًا في الجريمة. في ١٩ من العمر، حُكم عليَّ بالسجنِ لأول مرة؛ خمس سنوات بتهمة الاعتداء المُشدّد.
شعرتُ بالوحدة في السّجن أكثر مما كنت عليه في حياتي. كلُّ من كان من المفترض أن يُحبني ويحتضنني قد تخلى عني، استخدمني، وأساء إلي. أتذكرُ أنني استسلمتُ، حتّى أنني حاولتُ إنهاء حياتي. لفترة طويلة، واصلت الهبوط إلى الأسفل حتى التقيتُ “شارون” و”جويس”. لقد ضحوا بحياتهم للرّب. على الرغم من أنه لم يكن لدي أي فكرة عن يسوع، اعتقدتُ أنني سأجربها لأنني لم يكن لدي أي شيء آخر. هناك، محاصرةً داخل تلك الجُدران، بدأتُ حياةً جديدةً مع المسيح.
السقوط، الارتفاع، التعلّم…
بعد حوالي عام ونصف من عقوبتي، تقدّمتُ بطلب الإفراج المشروط. بطريقةٍ ما، كنتُ أعلمُ في قلبي أنني سأحصل على الافراج المشروط لأنني كنت أعيشُ من أجل يسوع. شعرتُ كأنني كنتُ أقوم بكل الأشياء الصحيحة، لذلك عندما جاء الرّفض مع بداية العام، لم أفهم. بدأتُ استجواب الله وكنتُ غاضبتًا جدًا.
في هذا الوقت تم نقلي إلى إصلاحية أخرى. في نهاية خدمات الكنيسة، عندما مد القسيس يدهُ للمصافحة، تراجعتُ وانسحبتُ. لقد كان رجلاً مليئًا بالروح، وقد أظهر له الروح القدس أنني قد تأذيت. وفي صباح اليوم التالي، طلبَ رؤيتي. هناك في مكتبهِ، كما سأل عمّا حدث لي وكيف كنت أتألم، فتحتُ قلبي وشاركت لأول مرة في حياتي.
أخيرًا، بعد خروجي من السجن وفي مركز إعادة التأهيل الخاص، بدأتُ العمل وكنتُ أتمسكُ بحياتي الجديدة ببطء عندما التقيتُ بـ “ستيفن”. بدأتُ بالخروج معهُ، وأصبحتُ حامل. أذكرُ كمْ كنتُ متحمسةً لذلك. كما أنه أراد أن يكون الأمر صائب، فتزوجنا وكوّننا عائلة. كان ذلك بمثابة بداية أسوء ١٧سنة من حياتي، والتي تميّزت بالإيذاء الجسدي والخيانة والتأثير المستمر للمخدرات والجِرِم.
حتّى أنه كان يريد أن يقدم على إيذاء أطفالنا، ما جعلني في حالة من الغضب الشديد؛ كنتُ أرغبُ في إطلاق النار عليه. في تلك اللحظة، سمعتُ هذه الآيات: “لي الانتقام، وأنا أُجازي.” (روما ١٢: ١٩) و”سيقاتل الرّب من أجلك” (خروج ١٤: ١)، وهذا ما دفعني إلى تركه يذهب.
أبدًا مُجرمة
لم أتمكن أبدًا من أن أكون مجرمةً لفترة طويلة؛ سوف يعتقلني الله ويحاول إعادتي إلى المسار الصحيح. على الرغم من جهوده المتكررة، لم أكن أعيش من أجله. لقد احتفظتُ بالله دائمًا، على الرغمُ من أنني كنتُ أعرف أنه كان هناك. بعد سلسلة من الاعتقالات والافراجات، عُدتُ أخيرًا إلى المنزل نهائيًا في ١٩٩٦. عُدتُ إلى الكنيسة وأخيرًا بدأتُ ببناء علاقة حقيقية وصادقة مع يسوع. بدأتْ الكنيسة رويدًا رويدًا تُصبح حياتي؛ لم أحظى حقًا بهذا النوع من العلاقة مع يسوع من قبل.
لم أستطع الحصول على ما يكفي من ذلك لأنني بدأتُ أرى أنه ليس الأشياء التي قمت بها ولكن مَن أنا في المسيح الذي سيبقيني على هذا الطريق. لكن، حدث التحويل الحقيقي مع “الجسور إلى الحياة”*.
كيف لا؟
على الرغم من أنني لم أشارك في البرنامج كمجرمة، إلا أن قدرتي على المساعدة في تلك المجموعات الصغيرة كانت نعمة لم أتوقعها؛ وهي نعمة من شأنها أن تغير حياتي بطرق جميلة. عندما سمعتُ نساء ورجال آخرين يشاركون قصّتهم، نقر شيء بداخلي. وأكّد لي أنني لم أكن الوحيدة وشجعني على الحضور مرارًا وتكرارًا. كنتُ سأشعر بالتّعب الشديد والإرهاق من العمل، لكنني كنتُ أدخل إلى السجون وأستعيدُ نشاطي لأنني كنتُ أعلم أن هذا هو المكان الذي كان من المفترض أن أكون فيه.
“الجسور إلى الحياة” يتكلّم عن تعلّم مُسامحة نفسك؛ لم تساعدني فقط مساعدة الآخرين على أن أصبح كاملةً، بل أيضًا ساعدتني على التعافي…وما زلت أتعافى.
أولاً، كانت والدتي. كانت مصابة بالسرطان، وأحضرتُها إلى المنزل؛ اعتنيتُ بها طيلة فترة بقائها حتى توفيت بسلام في منزلي. في عام ٢٠٠٥، عادَ سرطان والدي، وقدّر الأطباء أنَّهُ لم يتبقَّ له سوى ستة أشهر على الأكثر. أحضرتهُ إلى المنزل أيضًا. قال لي الجميع ألا أستقبلَ هذا الرجل بعد ما فعلهُ بي. سألت: “كيف لا؟” غفرَ لي يسوع، وأشعرُ أن الله يريدُ مني أن أفعل هذا.
لو أنني اخترتُ التمسكَ بالمرارةِ أو الكراهية تجاه والديَّ بسبب الهَجِر والإساءة، لا أعلم ما إذا كانا سيقدّمان حياتهما للرّب. بمجرّد النظر إلى حياتي، أرى كيف استمر يسوع في مُتابعتي ومحاولة مساعدتي. كنت مقاومةً جدًا للشعور بما هو جديد، وكان من السهل جدًا البقاء فيما هو مريح، لكنني مُمتنة ليسوع لأنني تمكنتُ أخيرًا من الاستسلام له تمامًا. إنه مخلّصي، إنه صخرتي، إنه صديقي. لا أستطيع أن أتخيل حياة بدون يسوع.
'
كلّنا نتصارع مع الله في وقت أو آخر، ولكن متى نُحقق السلام حقا؟
قالت لي مؤخّرًا صديقة تُكافح: “أنا لا أعرف حتى ما أصلي من أجله.” أرادت أن تُصلّي ولكنها سَئِمت من طلب شيء لن يتحقق. فكرتُ على الفور في طريقة الصلاة الإفخارستية التي وضعها القديس بطرس جوليان إيمارد. وهو يدعونا إلى أن نصمم وقت صلاتنا على غرار النهايات الأربعة للقداس: السُجُود، والشكر، والغُفران، والتوسّل.
طريقة أفضل
الصلاة هي أكثر من الطّلب، ولكن هناك أوقات عندما تكون احتياجاتنا والمخاوف حول أحبائنا ملحّة بحيث لا نفعل شيئا سوى أن نطلب، ونطلب، ونتوسّل، ومن ثم نطلب أكثر. قد نقول: “يا يسوع، أترك هذا بين يديك”، لكن بعد ٣٠ ثانية، نُخرجه من يديه مباشرةً لشرح سبب حاجتنا إليه مرة أخرى. نحن قلقون، مرتبكون، ونفقد النوم. لا نتوقف عن الطلب لفترة كافية لسماع ما قد يحاول الله أن يهمس به لقلوبنا المرهقة. نتصرّف بهذه الطريقة لبعض الوقت، والله يسمح لنا بذلك. إنه ينتظر أن نرهق أنفسنا، لندرك أننا لا نطلب منه مساعدتنا، ولكننا نحاول أن نقول له كيف نعتقد أنه يحتاج إلى مساعدتنا. عندما نتعب من المصارعة ونستسلم أخيرًا، نتعلّم طريقة أفضل للصلاة.
يعلّمنا القديس بولس في رسالته إلى أهل فيليبي، كيف يجب أن نتوجه بطلباتنا إلى الله: “لا تَقلَقوا أبدًا، بَلِ اَطلُبوا حاجَتكُم مِنَ اللهِ بالصّلاةِ والابتِهالِ والحَمدِ. وسَلامُ اللهِ الذي يَفوقُ كُلّ إدراكٍ يَحفَظُ قُلوبَكُم وعُقولَكُم في المَسيحِ يَسوعَ.” (٦:٤-٧)
محاربة الأكاذيب
لماذا نضطرب؟ لماذا نَقلق؟ لأنه، مِثل القديس بطرس، الذي توقف عن النظر إلى يسوع وبدأ يغرق (متى ٢٢:١٤-٢٣)، فإننا أيضًا نغفل عن الحقيقة ونختار الاستماع إلى الأكاذيب. تكمنُ في جذور كل فكر قلق كذبة كبيرة؛ أن الله لن يعتني بي، وأن أي مشكلة تقلقني الآن هي أكبر من الله، وأن الله سيتخلى عني وينساني؛ وأنه ليس لديَ أبًا مُحب بعد كل ذلك.
كيف نحارب هذه الأكاذيب؟ بواسطة الحقيقة.
يُذكّر القديس بيتر جوليان إيمارد أنًهُ “يجب علينا تبسيط عمل أذهاننا من خلال نظرة بسيطة وهادئة لحقائق الله”.
ما هي الحقيقة؟ أحبُّ إجابة القديسة الأم تيريزا: “التواضع هو الحقيقة.” يُخبرنا التعليم المسيحي أن ” التواضع هو أساس الصلاة.” تَرفع الصلاة قلوبنا وعقولنا إلى الله. إنها محادثة، وعلاقة. لا أستطيع أن أكون في علاقة مع شخص لا أعرفه. عندما نبدأ صلاتنا بتواضع، نعترف بحقيقة من هو الله ومن نحن. نُدرك أننا، بمفردنا، لسنا سوى خطيئة وبؤس ولكن الله قد جعلنا أولاده وأنه يمكننا أن نفعل كل شيء بواسطته (فيلبي ٤: ١٣).
إن هذا التواضع، وهذا الحق، هو الذي يقودنا إلى السُجُود أولاً، ثم الشكر، ثم التوبة، وأخيراً التوسّل. إنه التطور الطبيعي لمن يعتمد كليًا على الله. لذلك عندما لا نعلم ماذا نقول لـ لله، دعونا نُمجّدهُ ونحمد اسمه. دعونا نفكر في كل النِّعَم ونشكرهُ على كل ما فعله من أجلنا. سيساعدنا هذا أن نَثِق بأن هذا الله نفسه، الذي كان دائمًا معنا، لا يزال هنا اليوم ودائما من أجلنا خلال الأوقات الجيدة والأوقات الصعبة.
'
لقد فقدتُ هاتف “أيفون” الخاص بي منذ عام. في البداية، شعرتُ وكأن أحد أطرافي قد بُتر. لقد امتلكتُ هاتفًا لمدّة ثلاثة عشر عامًا، وكان الأمر بمثابة امتداد لنفسي. في الأيام الأولى، استخدمتُ الـ”أيفون الجديد” كهاتف، ولكن سرعان ما أصبح مُنبّه، آلة حاسبة، الأخبار، الطّقس، الخدمات المصرفيّة، وأكثر من ذلك بكثير، ومن ثمّ ذَهَبَ.
بما أنني كنتُ مُرغمة على التخلّص من السّموم، كان لدي الكثير من المشاكل الملحّة. يجب عليّ الآن كتابة قوائم التسوق الخاصة بي على الورق. تمّ شراء منبّه، وآلة حاسبة. اشتقتُ إلى “البينغ” اليوميّة من الرسائل والصراع على فتحها (والشعور بأنه مرغب بك) .
لكنني كنتُ أشعرُ بالسلام لعدم وجود هذه القطعة المعدنية الصغيرة التي تهيمن على حياتي.
لم أكن أعلم كم كان الجهاز متطلّب ومهيمن حتّى ذَهبَ. لم يتوقّف العالم. كان يجب عليّ أن أتعلّم طرق قديمة جديدة من التفاعل مع العالم، مثل التكلّم مع الناس وجهًا لوجه ووضع خطط للمناسبات. لم أكن في عجلة لاستبداله. في الواقع، أدى زواله إلى ثورة مرحّب بها في حياتي.
بدأتُ اختبار الحدّ الأدنى من الإعلام في حياتي. لا صُحف، لا مجلاّت، لا مذياع، لا تلفاز، أو هاتف. احتفظتُ بـجهاز “أيباد” لرسائل البريد الالكتروني الخاص بالعمل، اخترتُ فيديوهات تطبيق “يوتيوب” لعطلة نهاية الأسبوع، والقليل من صفحات الأخبار المستقلّة. كانت تجربة ولكنها تركتني أشعر بالهدوء والسلام، مما مكنني من استخدام وقتي للصلاة والكتاب المقدّس.
يمكنني الآن التمسك بالله بسهولة أكبر، الذي “هُوَ هُوَ أَمْسًا وَالْيَوْمَ وَإِلَى الأَبَدِ.” (عب ١٣: ٨). تَطلُب منا الوصية الأولى وتقول “أحبب الرب إلهك من كل قلبك وعقلك وروحك وأحبب قريبك كنفسك” (مرقس ١٢: ٣٠- ٣١). وأتساءل كيف يمكننا أن نفعل ذلك عندما تكون أذهاننا مشغولة بهواتفنا معظم اليوم!
هل نحب الله حقا بعقولنا؟ روما ٢:١٢ تقول “وَلا تَتَشَبَّهُوا بِهَذَا الْعَالَمِ، بَلْ تَغَيَّرُوا بِتَجْدِيدِ الذِّهْنِ.”
أتحداك أن تمتنع عن وسائل الإعلام، حتى ولو لبعض الوقت وحتى قليلاً. تشعر بهذا الفرق المتغيّر في حياتك. فقط عندما نعطي أنفسنا استراحة سنكون قادرين على حب الرّب إلهنا بعقول متجددة.
'